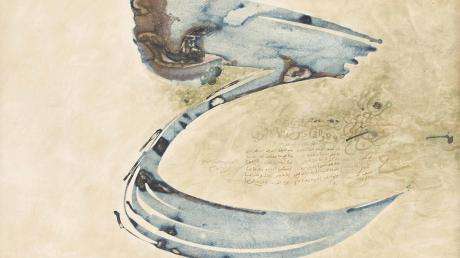التأخُّر في قراءة الشعر الجاهلي
يبدو الأمر غريباً حين تقصدُ مكتبةً بريطانية، فتجدها تحوي كتباً ومجلّات ومقالات ومصادر معرفية غنية جدّاً، مقارنةً بثقافتك الأصلية التي تنتمي إلى عالم آخر، وأقصد هنا العالم العربي. هذا بينما تفتقرُ معظم مكتبات العالم العربي إلى الموارد والمصادر المعرفية اللازمة لإجراء بحوث جديدة تتّسم بالكشف والاستكشاف، وتتماشى وروح العصر الذي نعيش فيه، وبالتالي تُجدّدُ الحياة وتثريها معرفياً وفكرياً وحسياً. هذه مشكلة ثقافية ووجودية يواجهها العالم العربي، ومن الصعب رؤية الحل في الأفق مع تغوُّل الطبقات الحاكمة على الثقافة كمجال مستقلّ وحرّ، بعيداً عن سياسة الإملاء والطاعة العمياء التي لا تنتجُ إلا أصناماً متحرّكة.
ويبدو الأمر أغرب حين تكتشف أنّ الدراسات الغربية (وأقصد هنا الأوروبية والأميركية على وجه التحديد) تأخذ النصوص الأدبية والثقافية العربية والإسلامية إلى مستوى آخر من الفهم والتحليل، فتصبح هذه المواد ذات قيمة كونيّة من ناحية تطوُّر الوعي الإنساني وأحوال الأمم العربية السابقة وأهميّة هذه النصوص بالنسبة إلى العصر الحالي.
لنركّز، هنا، على الشعر الجاهلي كمثال يُدرَّس بصوَر معيّنة في العالم العربي، بينما أخذت وتأخذ دراسته في العالم الغربي منحىً آخر. وبالطبع هناك نقاد عرب أبدعوا في فهم ثقافتهم وتحليلها، بينما هم في كنف الثقافة الغربية على وجه التحديد.
يُقرأ الشعر العربي وكأنّ كلّ بيت جزيرة منعزلة عن الأُخرى
قراءة الكثير من الكُتّاب العرب للتراث العربي، وخصوصاً الشعر، تتسم بالوصفيّة، أو بالحكم الأيديولوجي على النص. فعلى سبيل المثال، هنا نجد الكاتب أو القارئ يركّز على القصيدة كأبيات منفصلة لا كبنيان كامل متكامل له طاقة باطنيّة، وبالتالي معنى عضوي متكامل ذو أبعاد نفسية وفلسفية لا توضّحها قراءة النص بيتاً بيتاً. هذه الطاقة الكامنة هي التي تحرّك النص وتثبّتُ معانيه، فهي طاقة سياق محدّد وفلسفة أو رؤية معيّنة، أو شعور نابع من واقع معيّن يخص الشاعر. فمثلاً، عندما ندرس امرأ القيس أو المتنبّي، تعوّد أساتذة الشعر العربي العرب قراءة قصائده كأبيات، موضّحين المعاني والجماليات في كلّ بيت، ولا يتطرّقون إلى نفسية الشاعر التي تكتبُ وتحرّكُ وتطغى على القصيدة، أي المعنى الباطني والنفسي الذي يمكن أن يُشتقَّ من القصيدة التي نُظمَت في سياق هو في نهاية الأمر محدّد، وأيضاً ماذا يمكن أن تخبرنا هذه القصيدة عن الحالة الاجتماعيّة والسياسيّة للمجتمع الذي عاشت في كنفه. بعبارة أُخرى، كيف تكون النصوص الأدبية إبداعات فنية وجمالية، وكذلك مجتمعية وسياسية في آنّ واحد.
ولا يتفردُ العرب في دراسة الشعر العربي بهذه الطريقة، فهناك بعض المستشرقين الذين تعوّدوا قراءة الشعر العربي بتلك الطريقة أيضاً، أحياناً عن جهل، وأُخرى لكي يقلّلوا من مستوى هذا الشعر ومن قيمته الكونيّة، فقرأوا الأبيات وكأنّ كلّ بيت جزيرة منعزلة عن الأُخرى، لا كبنيان عضوي مرصوص تحرّكة فلسفة ونفسية معيّنة.
لكن أتى في القرن العشرين، وربما قبل ذلك من الدارسين العرب الأوائل (إذا جاز التعبير) في العصور الوسطى، من أنصف القصيدة بوصفها بناءً عضوياً كاملاً يتطلبُ تفسيراً بنيوياً يوضّح المعاني الكامنة وراء النص. ونذكر على سبيل المثال هنا دراسات كمال أبو ديب القيّمة التي استفادت من المدرسة البنيوية في تحليل النصوص الشعرية من العصر الذي يُسمّى بالجاهلي، حيث طبّق نظريات علماء فرنسيّين من أمثال ليفي شتراوس، والتشيكي رومان ياكوبسون، على صورة الظلام والنور في القصيدة ودلالاتها، وصور الخصوبة والجفاف، وكيف أنَّ هذه الصور تعكس تصنيفات كونيّة في تصوّرات وخيالات البشر.
سياسة الإملاء والطاعة العمياء لا تنتجُ إلا أصناماً
أتت بعد ذلك الناقدة سوزان ستتيكفتش لكي تقدّم إضافة نوعية إلى تحليل الشعر الجاهلي في كتابها "عندما يتكلّمُ الخالدون الصامتون: الشعر وشعريّة الطقوس في الشعر الجاهلي". في هذا الكتاب الفريد، تتعمّق الكاتبة في تحليل القصيدة (وخصوصاً المعلّقات) كبنيان متكامل تحرّكه أهواء ونزعات نفسية عميقة طفت شعراً في لغة الشاعر الفذّ. هنا تأتي بثلاث محطّات نظرية تقوم عليها القصيدة، وتتمثّل في فكرة الرحيل عن المكان أو القبيلة، ورحلة البحث عن النفس، والعودة إلى كنف القبيلة أو الجماعة: يعني هذا أن الشاعر يصابُ بمصيبة ما أو تعتريه رغبة جامحة ما تجعله يسافرُ ويرحلُ مع حيوانه بحثاً عن المعنى والتجديد، ويصفُ انفصاله عن قبيلته، ثمّ خلوته بنفسه في الصحراء أو البيئة التي مرَّ منها حيثُ يدرك وحشة النفس وعزلتها وهشاشتها أمام الطبيعة والوحدة، وبعد هذا الإدراك يعودُ إلى قبيلته، مستشرفاً خيراً من المستقبل مع الأهل والجماعة والقبيلة.
أليس في هذه القراءة عبَر كثيرة حين نتأمّل أحوال اللاجئين الكثيرين في عصرنا هذا وعلى مرّ العصور؟ هذه قراءة عصريّة حديثة تتخطّى حدود المكان والزمان.
وليت كثيراً من الدراسات في العالم العربي التي تركز على التراث تفعل ذلك، بدلاً من التقوقع الفكري، وإعادة تكرار أفكار ليس منها طائل ولا منفعة، بل على العكس تزيد من التفرقة بين البشر وبين الناس على أسس واهية وغير سليمة، وتبقى تدور في رحى فارغة عفا عليها الزمن وأصبحت حقّاً بالية.
التأصيل إبداع، وليس تكراراً وتقليداً، والنقد إضاءات عقليّة تنهض وتجدّد الحياة بما يليقُ ومعطياتها التي تتغيّر.
ربما آن للمكتبات العربية أن تزخرَ بمصادر تساعد على الإبداع وعلى الأصالة البناءة والفكر المُنفتح، وأنْ تُنارَ بالدارسين والدارِسات للخروج من الأنفاق الكثيرة التي يرزحُ فيها كثيرون في عالمنا العربي.
* كاتب وأكاديمي فلسطيني مقيم في لندن